تدوین الحدیث عربی (جلسه20)
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
أمس أشرنا إشارة عابرة إلى مسالك الأصحاب إبتداءاً قديماً وإلى يومنا هذا تقريباً إلى كيفية علاج الخبرين المتعارضين مع إشارة عابرة لأنّ التفصيل نذكره إن شاء الله تعالى إلى مبانيها أصولياً أو كلامياً المسلك الأول كان هو مسلك الطرح وقلنا شاع هذا المسلك في علماء بغداد مثل أمثال يونس والمسلك الثاني مسلك التخيير ذهب إليه جملة من الأعلام ونسب إلى شيخ الكليني على كلام فيه والمسلك الثالث مسلك الجمع والتأويل والتوجيه إختاره الشيخ الطوسي رحمه الله أيضاً من علمائنا البغداديين والمسلك الرابع مسلك الترجيح .
مسلك الترجيح أصولياً أولاً يبتني على حجية الخبر إما خبر العدل أو الثقة أو ما شابه ذلك وثانياً مبني على أنّه إذا كان الخبران متعارضين يعمل بما يكون إحتمال الريب فيه أقل من الآخر يعني بعبارة أخرى يلاحظ فيه لا ريب إضافياً لا حقيقياً لأنا إذا علمنا بوجود التعارض بينهما لا نصدق بصدورهما لا تشمل الأدلة أدلة الحجية للخبرين المتعارضين فيحصل ريب في أحدهما بطبيعة الحال كل ما كان الريب فيه أقل من الآخر يؤخذ به ويترك الآخر ، وهذه نكتة أصولية أيضاً ليست هذه النكتة كلامية مسلك الترجيح قلنا شاع عند السنة ولذا ذكروا شواهد لنفي الريب إضافياً الشواهد عقلائية وليست تعبدية ، قلنا في كتب السنة مثلاً ذكروا إذا كان الخبر أكثر عدداً أفضل من الخبر الآخر إذا كان أشهر إذا كان موافق لظاهر كتاب دون خبر الآخر فذكروا مرجحات قد تنتهي إلى سبعين أو ثمانين مرجح .
والوجه فيه سبق أن شرحنا أنّ السنة في القرن الأول والثاني لم يدققوا بالأسانيد إشتهر بينهم أنّ التدقيق في الأسانيد إنما حصل في أواخر القرن الثاني ولكن إلتجئوا في نفس الوقت إلى مسلك الحجية وغالباً إلى مسلك حجية الخبر العدل لا الثقة ، لم يؤمنوا بخبر حجية الثقة تعبداً لعدم وجود شيء من النصوص في ذلك إنما إلتزموا بحجية الخبر العدل الواحد ، إلتزموا بأنّه في خصوص الأحكام الشرعية خبر العدل الواحد حجة طبعاً توجهت إليهم إشكالات الآن لا أريد الدخول وعمدة الدليل قوله تعالى إن جائكم فاسق بنباء ، هذه عمدة الدليل عندهم بعد قبول هذا المسلك واجهوا الروايات المتعارضة لكن في مقام حل التعارض إلتجئوا إلى قاعدة عقلائية لا قاعدة شرعية لم يرد في شيء من النصوص لا في الكتاب ولا في السنة أنّ الرسول قال خذوا بالأكثر عدداً صلى الله عليه وآله إن الرسول قال خذوا بالأوثق خذوا بالأشهر لا يوجد عندهم رواية لا آية ولا رواية فلذا جمعوا بين مسلكين أولاً مسلك تعبدي وهو حجية خبر العدل الواحد طبعاً مو كلهم أكثرهم والثاني مسلك عقلائي وهو الأخذ بما فيه المرجح ترجيح بذي المزية .
والنكتة الفنية بالأخذ بأنّه بأدلة الإعتبار شمول هذين الخبرين المتعارضين في مرحلة الإقتضاء واحد لا فرق فيه يعني إن جائكم فاسق بنباء يشمل هذا الخبر وذاك الخبر ولكن في مرتبة الفعلية لا يعقل كلاهما فعلاً يكون حجةً لا لكن كل منهما في نفسه حجة لو لا المعارض فإنّه إذا كان أحدهما حجة في نفسه والآخر غير حجة في نفسه لا يتحقق التعارض بينهما لأنّ التعارض فرع الحجية في كليهما لكن إقتضاءاً فمسلك الترجيح يؤمن بدرجتين من الحجية في التحليل الأصولي درجة الإقتضاء وهو أن يكون الراوي عدلاً درجة الفعلية بأن لا يكون في قباله معارض ، بخلاف مسلك الطرح قد يسأل بعض الإخوة المسلك الأول الذي شرحناه مسلك الطرح كان خوب في باب الترجيح هم يطرح أحد الخبرين في باب الترجيح إذا رجحنا خبراً عن خبر آخر الخبر المرجح يؤخذ والآخر يسقط فكيف جعلنا مسلك الطرح في قبال مسلك الترجيح مع أنّ مرجعهما إلى شيء واحد على أي في كلى المسلكين يطرح أحد الخبرين الفرق بينهما في مسلك الطرح ما يذكر من الشواهد دخيل في مقومات الحجية بحيث إذا لم تكن مع الخبر تلك الشواهد والقرائن الخبر في نفسه غير حجة ولو لم يكن له معارض ، فيونس بن عبدالرحمن يقول الخبر الذي ليس عليه الشواهد من الكتاب والسنة ليس عليه توافق روحي ليس متوافقاً روحاً ع الكتاب مضموناً مع الكتاب والسنة في نفسه باطل ولو لم يكن له معارض ، مع قط النظر عن المعارض ولذا لا يؤمنون بدرجتين من الحجية فعلية وإقتضاء ، درجة واحدة وهي درجة فعلية .
صار الفرق بينهما واضحاً ، فرق كبير بين المسلكين ينبغي أن تعرف هذه النكتة وحسب ما وجدنا نحن إنصافاً قدماء أصحابنا لم يختاروا هذا الرأي الآن لا يحضرنا دقيقاً أنّ قدماء الأصحاب إختاروا مسلك الترجيح أصولاً سبق أن شرحنا أنّ مسلك القدماء حجية الخبر الموثوق به غالباً خصوصاً البغداديين منهم حجية الوثوق والإطمئنان أما القميون والخراسانيون فكان معروف خضوهم لكل خبر لا خصوص خبر العدل .
على أي كيف ما كان فقبول مسلك الترجيح عند قدماء الأصحاب الآن غير واضح نعم بعد إنتشار الأصول والأبحاث الأصولية إبتداءاً بشكل مختصر وجد هذا المسلك في كلمات الشيخ الطوسي في العدة ، بخلاف أستاذه مثلاً السيد المرتضى في الذريعة مثلاً ثم بعد ذلك وخصوصاً كل ما تأثرت المدرسة الأصولية الشيعية وأفكار السنة دخلت هذه الترجيحات في كلمات المتأخرين على رأسهم مثل المحقق قدس الله نفسه في المعارج العلامة في كتبه الأصولية ثم عند متأخر المتأخرين حاول إشتهر هذا المطلب في الأصول عند علمائنا قدس الله أسرارهم حاولوا أن بإصطلاح يستفيدوا هذا الترجيح من النصوص ولذا في الآونة المتأخرة يعني بعد القرن العاشر والحادي عشر حاول الأصحاب الجمع بين الأمرين أولاً يأخذوا النصوص ويستفيدوا منها مسلك الترجيح .
وكان من أبرز المحاولات الإعتماد على رواية عمر بن حنظلة لإثبات الترجيح ، ولذا رواية عمر بن حنظلة جعلت من المرجحات بل سبق أن شرحنا أنّ الأستاذ أطال الله بقاه إستفاد من هذه الرواية المباركة الترجيح بكل مرجح وإن لم يذكر في هذه الرواية بإعتبار كلمة لا ريب فيه ، بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، على أي كيف ما كان والإنصاف أنّ مسلك الترجيح عند المتأخر المتأخرين من أصحابنا يعني متأخر تأخيري من جهة الخصوص وإنما أنّ المتأخرين هم موجود وسبق أن شرحنا أنّ رواية عمر بن حنظلة أقرب إلى مسلك الطرح منهم إلى مسلك الترجيح .
مفاد رواية عمر بن حنظلة مسلك الطرح وأنّ الخبر إذا كان شاذاً أو إذا ليس عليه موافق من الكتاب والسنة أو فيه إحتمال التقية أو شارة التقية يسقط عن الإعتبار رأساً فلذا الرواية تعرضت لتمييز الحجة عن اللا حجة واختار هذا المعنى أيضاً صاحب الكفاية والمحقق العراقي لكن في بعض فقرات الرواية لا في كله الفرق بينها وبين محقق الخراساني وغيره أنّ هؤلاء آمنوا بهذا الشيء لكن في بعض الفقرات نحن نعتقد أنّ الرواية من صدرها إلى ذيلها في تمييز الحجة عن اللا حجة في بيان ما هو الحجة وما ليس بحجة لا في مقام الترجيح لإحدى الحجتين على الأخرى وهو مسلك الترجيح وبما أنّ الكلام تقدم لا نعيد هذا الكلام .
فتبين أنّ مسلك الترجيح أساسه حجية الخبر وأساسه سيرة عقلائية والإنصاف كلى الأساسين عندنا غير ثابت لا الأساس الأول عندنا ثابت بإعتبار مناقشتنا المعروفة في حجية الخبر العدل أو خبر الثقة أو ما شابه ذلك بل لا بد من الوثوق والإطمئنان كما عليه القدماء الأصحاب ويعبر عنه بالصحيح القدمائي وأما المسلك الثاني وبمجرد وجود مرجح في أحد الخبرين يقدم هذا أشبه شيء بالعمل بالظن لا دليل على أنّه هذا رواته إثنين ذاك راويه واحد هذا يكفي في الأخذ بالمرجح دون الآخر بالعين .
إذا كان النظر في ذلك إلى إعتبار شرعي قلنا لم يثبت إذا كان نظر إلى إعتبار العقلائي لا إشكال أنّ العقلاء إذا بعضهم يختار هذا الشيء مو كلهم والإعتماد على أمر عقلائي ليس من المتفق عليه بين الكل جداً صعب لأنّ الإعتبارات العقلائية والإرتكازات العقلائية بعد قبول الشارع لها تكون معتبرة وأما إذا كان مختلفاً يكون معتبراً هذا محل إشكال على أي هذا أشبه شيء بمسألة الظن مو أشبه شيء هو بعينه فمرجعه إلى حجية الظن فقد ثبت في محله الأصل الأولي عدم حجية الظن فهذه الظنون الترجيحة مما لا يمكن إثبات التعبد بها ولذا مسلك الترجيح أصولاً عندنا ببطلان أساسيه في نفسه غير تام .
هذه مسالك أربعة للأصحاب من القديم إلى يومنا هذا فقط المسالك الثلاثة عند القدماء موجودة مسلك الترجيح عند المتأخرين موجودة وطبعاً نحن لو نكون نحن مع الروايات إنصافاً مسلك الطرح الذي إختاره مثل يونس وشيخ المفيد وسيد المرتضى وقاطبة البغداديين بتعبير والمحصلين من أصحابنا إنصافاً أقرب إلى الإعتبار وأقرب إلى شواهد الصدق ويتبين بقية المسالك وتفصيل هذا المسالك هم في ما سيأتي إن شاء الله ، هذا قلنا ما ينبغي أن يذكر قبل الدخول في علل تعارض الروايات .
ثم نقول بإذن الله تعالى أنّ علل تعارض الروايات تنقسم إلى قسمين رئيسين علل ثبوتية بإصلاحنا وعوامل ثبوتية وعوامل إثباتية مرادنا بالعلل وعوامل الثبوتية يعني مع فرض صدور كلى الكلامين واقعاً من الإمام يعني الحديثان المتعارضان المختلفان صدرا من الإمام بالفعل صدرا ولا نتصور أنّه من إختلاف النسخة أو هذا الناقل إشتبه لا صدر حديثان متعارضان من الإمام لماذا صدر إبتداءاً لا تعرف الأسباب إلا بأشيائها ، إبتداءاً نعرف السبب والعامل والعلة في وجود هذا الإختلاف ثم نأتي إلى حله هل يمكن صدور حكمين مختلفين من إمام أو من إمامين أم لا وما هو الحل لحل هذا الإختلاف .
الأمر الثاني ما يرجع إلى العلل إثباتية يعني مو معلوم أنّ الكلامين صدرا من الإمام النسخ مختلفة الناقل قد إشتبه الطرق الكلام في الطريق إليه هذا المورد الثاني وهناك قسم ثالث يمكن إلحاقه تارةً بالقسم الأول وأخرى بالقسم الثاني بلحاظ ولو إلحاقه بالقسم الأول أفضل ، وهو ما يرجع إلى جهات في فهم كلماتهم يعني لعله الكلام ولو يستفاد منه التعارض إبتداءاً بالتأمل في بعض جهاته يتبين ليس متعارضاً أو بعبارة أخرى جهاة دلالية في كلماتهم سلام الله عليهم أجمعين لا ثبوتية ولا صدورية بل دلالية ، يعني بعبارة أخرى قد إنسان يفهم إبتداءاً من الكلام ظاهر من الكلام التعارض لكن لما يتأمل في أطراف الكلام ويدقق النظر يرى أنّه لا تعارض فيه وهذه المسألة أصولاً مسألة فهم الكلام هذا شيء مما لا إشكال فيه أنّ سوق العقلائي قائم عليه يعني العقلاء والشعراء الأدباء أصحاب البلاغة تأكيدهم على الفهم إبتداءاً وفهم الكلام وصياغ الكلام وخصائص الكلام ولطائف الكلام ودقائق الكلام يعني وجدت علوم خاصة لهذه الجهة علوم المعاني والبيان والبديع وقسم من اللغة إنما أسست لفهم الكلام وللدقائق الموجودة في الكلام .
إضافةً إلى ذلك في نفس الآيات المباركة أفلا يتدبرون القرآن ، تدبر والتعقل والفهم وخصوصاً جاء في لسان رسول الله أكثر من القرآن في لسان رسول الله نظر الله إمراءاً وهذه الرواية صحيحة سنداً عندنا وعند السنة بل كاد أن تكون متواترة ، نظر الله إمراءً أنا قلت ذاك اليوم إختلف بين علماء الحديث نظّر الله إمراءً يا نظر الله إمراءً بالتخفيف والتشديد في تصورنا التخفيف أفضل من التشديد ومن باب علم بكسر اللام نظر الله إمراءً سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها لاحظوا التعبير فوعاها مو فقط سمعها الإدراك الصحيح والفهم الصحيح ثم بلغها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه يحتمل هو يحتمل في الحديث معنى لكن شخص آخر لما ينقل له يقول لا المراد الجدي هذا المعنى .
ففهم الجهات وفهم النكات وفهم دقائق الكلام هذا من الأمور التي جداً مهمة في فهم التعارض في رواياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، فهذه جهات جهتين رئيسيتين وجهة ملحقة بالجهة الثبوتية جهة الدلالة ، فيقع الكلام في هذه الجهات أما جهة الدلالة نبداء به قسم كبير من هذه الأبحاث من إبداعات السيد الأستاذ أطال الله بقاه أما جهة الدلالة خوب لا إشكال أنّ كلمات أهل البيت ككلمات غيرهم من العرب من الفصحى فيه إحتمالات إنّ الكلمة تكون على سبعين وجهاً أولها في شيء وآخرها … إنّ الكلمة تنصرف إلى سبعين وجهاً إنّ الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء لا إشكال مع قطع النظر عن كلمات الأئمة عليهم السلام أصولاً الكلام خصوصاً إذا كان وصدر من إنسان عالم جداً مطلع جداً دقيق جداً فطن جداً يحتمل عدة وجوه إحتمالاً هذا طبع القضية ، المشكلة الأساسية في روايات أهل البيت هذه ينبغي أن تذكر في هذا المجال وهي السبب في الإختلاف في الرواية يعني وهي السبب في أنّه يصعب علينا الآن حل التعارض في كلماتهم يعني أوجد التعارض وصعب علينا الحل هي أنّ الأئمة عليهم السلام كالنبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه ما كتبوا كتاباً مستقلاً بعنوان سنن البني أو الأحكام الشرعية مثل الرسالة العملية في زماننا جل ما ورد بل كل ما ورد تقريباً يعني أكو كتابات ورسائل مختصرة جل ما ورد عنهم سلام الله عليهم أجمعين ما ورد عنهم في المشافاهات والكلام مع الأشخاص وكم من فرق بين المطلبين بين أنّ الإنسان يكتب كتاباً أفرضوا الشافعي كتب كتاب الأم ، أفرضوا المالك كتب موطئ ، بين أن يكتب الإنسان كتاباً وبين أن يبتلى بأشخاص يسألونه فيجيب .
وخصوصاً الآن نرى مثلاً عن أبي عبدالله قال لا بأس بالمعتدة تخرج خوب حتماً سؤال موجود كلام موجود قبله فد شي موجود بعيد جداً إنسان يدخل في البين الإمام يقول لا بأس الإنسان يقول في سجوده كذا حتماً سؤال فد جواب فد خصوصية ، فلذا كلمات أهل البيت تأملوا النكتة هذا هو الأساس في هذا المحور ما صدرت الروايات بصورة تأليف كتاب فقهي مدون وإنما صدرت الروايات بحسب المشافهة مع الأئمة عليهم السلام.
ونحن الآن لما نتأمل في هذه الروايات نجد أنّ هذه الروايات على طائفتين لا طائفة واحدة ، لو كانت الروايات بصورة كتاب بيان الأحكام بصورة كتاب كما الآن في المجلس الشورى مثلاً مجالس القانونية موجود خوب هذا يكون بقاعدةً بلسان الواحد وهو بيان الكبريات أصلاً طبيعة القانون بيان الكبريات لكن بما أنّ هذه الروايات صدرت مشافهةً لذا بطبيعة الحال رواياتهم سلام الله عليهم أجمعين تنقسم إلى قسمين قسم منها لبيان الكبريات ولإلقاء الكبريات الكلية وكان الأستاذ أطال الله بقاه يعبر عنها مقام التعليم والقسم الثاني مقام تطبيق الكبريات لأنّ÷ لا إشكال أنّ في العلوم التخصصية وفي الأمور المهمة هسة دعنا عن الأمور العرفية كما أنّ إلقاء الكبريات مهم تطبيق الكبريات هم لا يقل منها أهمية إن لم يكن أهم .
مثلاً أنتم في علم الطب تقرؤون كليات الصداع يحصل من عشرين سبب الفلان يحصل كذا الحماء يحصل كذا إذا كان الصداع من هذا السبب علامته كذا علاجه كذا هذه كبريات لكن تعلمون أنّ الطبيب لا يحتاج إلى هذه الكبريات يحتاج إلى تطبيق الكبريات المريض لما يراجعه لا يريد منه الكبريات المريض لما يراجعه الطبيب يلاحظ أنّ هذا عنده صداع بحسب القرائن الموجودة سببه كذا والمزيل لهذا السبب هم كذا فيعطي له وصفة يدخل عليه شخص آخر أيضاً عنده صداع يشخص أنّ هذا الصداع سببه كذا ومزيله كذا ويكتب له وصفة أخرى تختلف بحسب الظاهر من تلك الوصفة ، صار واضح ؟
فنجد بوضوح أنّ شأن الطبيب علمه بأمرين لا بأمر واحد الكبريات ، فهم الكبريات وثانياً تطبيق الكبريات ، الأئمة عليهم السلام هم كذلك لهم شأنان وفي رواياتهم الآن بالفعل كلى الأمرين موجود قسم من الروايات بيان للأحكام الكلية وللكبريات الملقاة على الطائفة والقسم الثاني تطبيقات ونحن عادتاً نعبر عن التطبيقات في باب الفقه نعبر بالإستفتاء والإفتاء حقيقة الإفتاء عبارة عن تطبيقات الكبريات الشرعية على المورد المبتلى به الشخص ولذا قد يكون الشخص يعرف الحكم الكلي لكن لا يعرف حكم شخص وكلى الأمرين دخيل في الفقه لا أحدهما .
أولاً فهم الكبريات وإطلاع عن الكبريات مهم ثانياً التطبيق ، تطبيق الكبريات على المورد ، هل هذا المورد من مورد كذا أم من مورد كذا فالمشكلة الأساسية في بيان الكبريات بما أنّ الهدف إعطاء قابة الكلية يمكن بلحاظ التدرج في بيان الأحكام لا يذكر جميع المطلب ولذا بطبيعة الحال الكبريات تتحمل التخصيص والتغيير لأنّ الكبريات لا تعطى للعمل كبريات إنما تعطى وتلقى لفهم الحكم بخلاف الإستفتاء أما ما كان من قبيل الإستفتاء نقول هذه الرواية التي ظاهرة في الإستفتاء هذا مطلقة نقيدها برواية أخرى هذا غير صحيح ، في الإستفتائات التقييد غير صحيح ، يعني الفاصل الأساس أصولياً الذي يذكر في الأصول أنّ الكبريات بما أنّها ليست في مقام العمل تقبل التخصيص ، تقبل التقييد بلحاظ التدرج في زمان الإعلام في زمان بيان الحكم النبي كان يبين وأنزلنا إليك القرآن لتقرئها على الناس على مكث، حقيقة القرآن واحدة لكن قرائتها وبيان للناس يكون على إستمرار الأزمنة المختلفة وكذلك الأئمة عليهم السلام فما كان في مقام إلقاء الكبريات وإعطاء الكبريات يقبل التخصيص ولذا هذا هم الآن من شؤون التقييد في زماننا أن يعرف أنّ هذه الرواية من قبيل الكبريات أم أنّ هذه الكبريات من قبيل الإستفتاء.
مثلاً ورد في رواية على ما يقال صحيحة على كلام عندنا في صحتها عن علي بن سويد الساعي قال قلت له أبوالحسن الكاظم ، إني مبتلاء بالنظر إلى المرأءة الجميلة فيعجبني ذلك فقال عليه السلام لا بأس إذا علم الله من نيتك مضمون الرواية ، فأفتى بعضهم على أنّه يجوز النظر للمرأء ولو كان بشهوة فيعجبني ذلك نص الحديث الشريف هل هذا من الكبريات ؟ أم لما يقول إني مبتلاء ، إني مبتلاء صدر الحديث مشعر على أنّه تعمداً وإبتداءاً لا ينظر إلى المراءة ولذا بقرينة مبتلاء لا بد أن نقول مثلاً من باب المثال طبيب ولو الآن قلنا لا نؤمن بصحة الرواية طبيب لا بد له أن يعالج يد إمراءة مبتلاء معناه هكذا أمر غير إختياري ، خوب طبعاً إذا نظر إلى ساعدها قد يقع في قلبها شهوةً فحينئذ يعجبني لا بد على حملها يعجبني تكويناً لا تعمداً بقرينة مبتلاء وإلا كيف ، إذا كانت المراد ذلك لا يقول إني مبتلاء ، يقول إنّي أحب النظر إلى النساء فلما يقول إني مبتلاء بالنظر إلى المراءة فيعجبني ذلك نفهم أنّ الرواية المباركة من سنخ الإستفتاء لا من سنخ الكبريات ، فلذا طبعاً الفوارق ما بين الكبريات وما بين التطبيقات والإستفتاء كثيرة نذكر بعضها هنا إن شاء الله تعالى مفيدة جداً .
من جملة الفوارق ما بينهما وبعضها خلال بعضها يتبين أنّه في الكبريات طبيعة الأمر الروايات الصادرة كبرى تقبل التخصيص تقبل التقييد والرواية الصادرة إستفتاءاً لا تقبل التخصيص والوجه في الروايات الإفتائية تبين الوظيفة الفعلية لهذا المكلف هذا المكلف الآن يريد العمل وليس من الصحيح أنّ الإمام يذكر له جزءاً من الحكم وبقية الوظيفة يذكرها لراوي آخر أو إمام آخر أصلاً ليس طريقةً مألوفةً عقلائية في أنّ الإمام سلام الله عليه يبين شيئاً هو الآن مبتلاء هو الآن يريد العمل يبين له شطراً من الحكم وقيده يبينه لشخص آخر خلاف السلوك الخارجية .
نعم الفرق بين الكبرى وبين الإستفتاء قد يكون صعباً بلحاظ التطبيق والتشخيص الخارجي على أي إذا فقيه يعرف أنّه بحسب الشواهد الرواية كبرى أم الرواية إستفتاء ، الروايات الصادر ككبريات وككليات غالباً لا يلاحظ فيه موضوع خاص بخلاف الروايات الصادرة إستفتاءاً بإعتبار أنّ الروايات الصادر إستفتاءاً ناظرة إلى أشخاص معينة كالوصفة الصادرة من الطبيب لمريض خاص الإستفتاء من هذا القبيل الروايات الصادر ككبريات وككليات بعبارة أخرى يمكن فهمها بسهولة نوعاً ما لأنّه الإمام بين الحكم الكلي من مس ميتةً عليه كذا ، المراءة لا تحج إلا بإذن زوجها مثلاً خوب هذا حكم كلي فهمه لا يخلوا عن صعبوة سهل وأما فهم الحكم الكلي من الإستفتائات صعب ، وهذا يحتاج إلى فقاهة لأنّه لا بد أن يعرف أنّ الإمام طبق على هذا المورد شخص هذا المورد كذا وطبق عليه الحكم الكذايي مثلاً الآن لو كان عندكم كتاب في الطب الدواء الفلاني صالح للمرض الفلاني الصداع مثلاً ينفعه كذا هذا سهل لكن إذا أنتم عندكم وصفات طبيب واحد كتب عشرين وصفة لعشرين شخص تستنتجون الحكم الكلي من هذه الوصفات الشخصية هذا صعب هذا يحتاج إلى طبيب غير الطبيب لا يفهم ، غير الطبيب فقط يعرف الوظيفة الفرعية يعني غير الطبيب فقط يعرف أنّ هذا الشخص وظيفته أن يفعل هذا ، هذا يفهم به غير الطبيب وأما ما هي النكتة في ذلك ، ما هو الشيء الذي شخصها الطبيب ما هو المرض الموجود وكيف عالج فنياً هذا المرض من مجموع الوصفات المختلفة لا يعرف هذا الشيء إلا أن يكون الشخص طبيباً متخصصاً .
وكيف ما كان ، فأهم شيء النكتة الأساسية أنّ روايات أهل البيت صدرت مشافهةً هذا الأساس ليست الآن عندنا كتب عن أهل البيت ككتاب الأم للشافعي أو موطئ مالك لو كان كذلك لكان كل كبريات ليس فيه تطبيقات ، وأما إذا كان كلماتهم صادرة بنحوين كبريات وإستفتائات … على أي كيف ما كان فحينئذ المهم في معرفة نصوص أهل البيت أن نعرف أنّ هذا من سنخ الكبرى أم من سنخ الإستفتاء ومعرفة هذه النكتة تؤثر كثيراً في فهم كلماتهم من جهة وفي حل بعض موارد التعارض من جهة وهذا الذي ينفعنا ، توضيح ذلك قلنا أنّه في الإستفتائات يلاحظ الشخص بعينه بخلاف الكبريات الذي لا يلاحظ الشخص ولذا قد يصدر هناك بحسب الظاهر تعارض في الرواية لأنّه كان من سنخ الإستفتاء والإمام لاحظ شخصاً صدر منه حكم لاحظ شخصاً آخراً صدر حكم آخر فيتصور التعارض ونذكر بعض الشواهد على ذلك .
جاء في كتاب الوسائل في أبواب الحج الجزء التاسع حديثان أحدهما مفصل والآخر مختصر أقراء كليهما السند معتبر إلى أبي أيوب بسند صحيح إلى أبي أيوب الخزاز عن سلمة بن محرز ، هذا سلمة بن محرز لم يرد فيه توثيق ولكن إنصافاً رأينا أنّ أعلام الطائفة مثل أبي أيوب هنا ، محمد بن مسلم ، إبن أبي عمير هؤلاء الأعلام رووا عنه إنصافاً يبدوا شخص معرفتنا به قليلة وإلا لا بأس إجمالاً قال سألت أباعبدالله عليه السلام ثم جهالة الراوي الأخير إذا فرضنا ينقل قصةً رتب كبار الأصحاب أثراً عليه جهالته لا تؤثر عرفتوا النكتة ؟ لأنّه ينقل هذا الحكم مثل أبي أيوب وأبي أيوب هم ينقله كحكم بين الأصحاب ، فجهالته … غايته هناك مجهول هذه الجهالة لا تؤثر .
قال سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء يعني يوم العاشر من ذي الحجة أتى بأعمال المنى ثم جاء إلى مكة وطاف طواف الحج ثم سعى بين الصفاء والمروة وصلى أتى بالأعمال بعده لم يطوف طواف النساء فتصور أنّ الأعمال خلصت تأملتم ، تصور بعد إتيان الطواف والحج والسعي والصلاة الطواف كذا فيحل له كل شيء تصور هذا الشيء بعد لم يأتي بطواف النساء فتصور أنّه بهذا الشيء يعني مبيت منى عمل مستقل لا ربط له وهو هكذا بإستثناء طواف النساء تعمل مستقلاً ،قبل أن يطوف طواف النساء قال ليس عليه شيء خوب الإمام أجاب ، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا إتقاه هذه تقية ، بسرعة قالوا إتقاه هذا ميسر ، ميسر خادم الإمام مولاه قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة ، خوب كيف يعقل سؤال واحد بحسب الظاهر سؤال واحد رجلين من أصحابنا سأل الإمام لعله ظاهراً في سنة واحدة ميسر خادمه سأل قال عليك بدنة سأل سلمة بن محرز قال ليس عليك شيء فلذا أصحاب لاحظوا فهم الكلام ، أصحابنا بسرعة حملوها على التقية ، هنا حقيقة الفقاهة تتبين .
قالوا إتقاه هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة ، قال سلمة فدخلت عليه فقلت جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني فقالوا إتقاه هذا ميسر قد سأله عن ما سأل فقال له عليك بدنة ، كيف يعقل إختلاف الجواب منكم فقال عليه السلام إنّ ذلك كان بلغه فهل بلغك قلت لا قال ليس عليك شيء لاحظوا هذا مثل وصفة واحدة لمريضين كلاهما صداع عنده لكن الوصفة مختلفة .
الإمام في مقام الجواب لاحظ حال السائل من دون أن يلتفت هو ، ميسر خادمه وكان معه ويعلم بأنّ هذا لا يجوز ، لا يجوز إتيان الأمر قبل طواف النساء فلما سأل الإمام أجاب عليك بدنة لكن هذا من سنخ الإستفتاء لا من سنخ الحكم الكلي ، يعني أنت الشخص المعين الذي إسمك ميسر لعلمك هذا عليك بدنة وأما سلمة عرف الإمام من حالاته ما كان يدري حسباله إذا أتى بطواف الحج والسعي بعد يحل له كل شيء حتى النساء ، فلذا الإمام قال أبلغك قال لا قال ليس عليك شيء ، ولذا في ما بعد الأصحاب بعد … يعني هذا شأن الفقيه يعلم من الوصفات الحكم الكلي وإلا الحكم الكلي إبتداءاً فهمه في غاية الصعوبة والإشكال هذا النص بشكل مفصل موجود لا بأس به .
هذا هم بنفس السند عن أبي أيوب قال حدثني سلمة بن محرز أنّه كان يتمتع مراد بالتمتع في كتاب الوسائل الجزء التاسع من كتاب الوسائل من الطبعة المألوفة صفحة مائتين وخمسة وستين في أبواب التعارض عن أبي أيوب قال حدثني سلمة بن محرز أنّه كان يتمتع مراد بالتمتع هنا مو المتعة يعني حج التمتع ، حتى إذا كان يوم النحر أو كان يومُ النحر بمعنى كان ناقصاً ، طاف بالبيت وبالصفاء والمروة ثم رجع إلى منى ، رجع إلى منى للبيتوتة طبعاً البيتوتة في متى إنسان بعد محل ولم يطف طواف النساء ، ثم فوقع على أهله فذكره لأصحابه قالوا فلان قد فعل مثل ذلك فسأل أباعبدالله فأمره أن ينحر بدنةً ، لاحظوا يعني نفس السؤال لم يلتفتوا إلى خصوصية الإستفتاء قال سلمة فذهبت إلى أبي عبدالله عليه السلام فسألته فقال ليس عليك شيء فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي قلت عجيب أنتم تقولون عليك بدنة ، بنفس السؤال .
لاحظوا هنا ليس العلة في تعارض الحديث مسألة الجوانب الإثباتية لأنّه شخص واحد سأل الإمام مو أنّه إحتمال في صدور ، العلة في إختلاف الحديث عدم الوصول إلى مراد الإمام في مقام الدلالة لم يتبين له النكتة في كلام الإمام فأخبرتهم بما قال لي قال فقالوا إتقاك فأعطاك من عين كذبة خوش تعبير لأصحابنا ، وأعطاك من عين كذبة فرجعت إلى أبي عبدالله عليه السلام فقلت إني لقيت أصحابي فقالوا إتقاك فقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمرته أن ينحر بدنة قال صدقوا ما اتقيتك أيضاً يعني كلى الأمرين صحيح هم ذاك الكلام صحيح هم تقية من جهة الصدور هم ليس فيه إشكال ولكن فلان فعله متعمداً وهو يعلم وأنت فعلته وأنت لا تعلم فهل كان بلغك ذلك قال قلت لا والله ما كان بلغني قال ليس عليك شيء .
فلاحظوا في هذه الرواية هو رجل كان موجود لكن هذا لا ينتهي الأمر في هذا المجال في هذه الرواية المباركة بعض الأصحاب شعر بالتعارض في رواية تبين لا التعارض منشائه أنّ النكتة الأساسية في باب الإستفتاء ملاحظ حال الشخص دون إعطاء الحكم الكلي شاهد آخر على ذلك ما جاء في الوسائل الجزء التاسع أيضاً في باب الحج صفحة مائة وخمسة وتسعين من الطبعة الشيخ الرباني رحمه الله الشيخ الصدوق بإسناده عن خالد بياع القرانس فيه كلام ، قال سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء فقال عليه بدنة ثم جاء آخر فقال عليك بقرة ثم جائه آخر فقال عليك شاة ، خوب الشخص تحير هو بنفسه خالد بياع القرانس يعني الخالد القرانسي الإمام قال عليك بدنة يعني بعير بإصطلاح إبل ، ثم بقر ثم شاة بلي ، فقال فقلت له بعد ما قاموا أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة عليه أظن علي يعني ، فقال عليه السلام عليك أنت موسر وعليك بدنة يعني الإمام مضافاً إلى بيان الحكم الكلي كأنما هذا الشخص لما يدخل عليه يريد ماذا يعمل الآن يخرج من عندنا ماذا يأتي به العمل الوظيفة العملية ، الوظيفة العملية شأنه الإستفتاء ، بعض النفوس لا تتحمل بهذا الحكم الكلي شخص إمام يعرفه موسر بدل أن يقول إن كان موسراً كذا ، يقول أنت إذبح بدنة إبتداءاً يحكم ، رجل الثاني كان متوسطاً قال إذبح بقرة رجل الثالث كان ضعيف الحال قال إذبح شاتاً فقال عليه السلام أنت موسر وعليك بدنة وعلى الوسط بقرة وعلى الفقير شاة . مع أنّه في مجلس واحد الإمام أجاب ثلاث أجوبة تبين لا تعارض فيه إطلاقاً .
ومنشاء الفهم الخلط بين الكبريات يعني نتصور إذا قال عليك شاة يعني كل من يطف طواف النساء عليه شاة ، والإمام بين لا أنّه قلت له عليه شاة من سنخ الإستفتاء هو الآن يذبح شاتاً فقط بوظيفته العملية الشخصية وأما النكتة الفنية شيء آخر وإن شاء الله للكلام تتمة .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
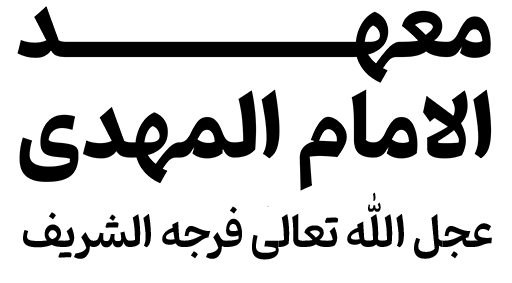
دیدگاهتان را بنویسید